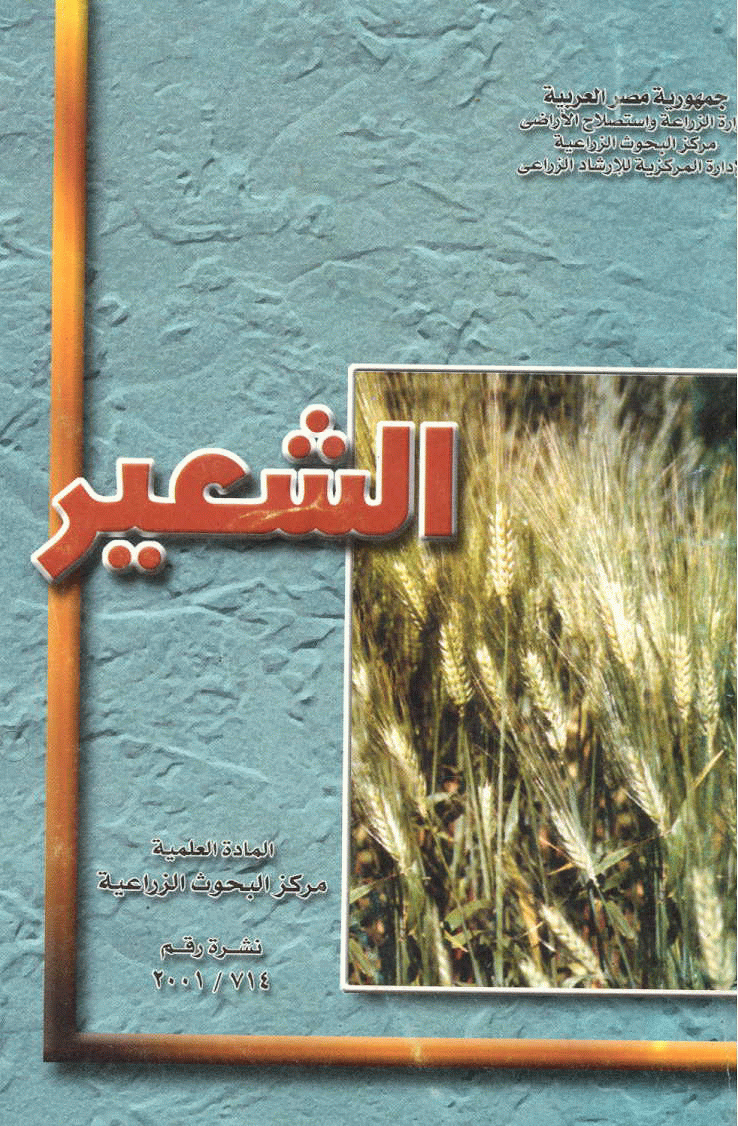 وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي
وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي
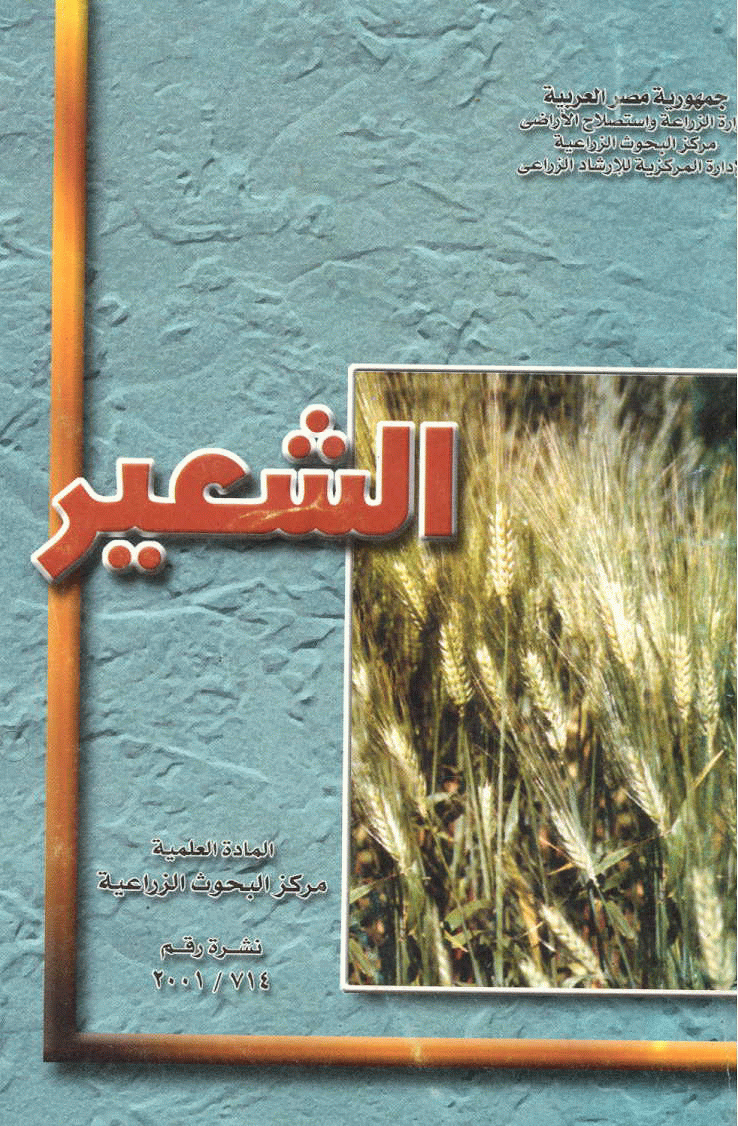 وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي
وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي
مركز البحوث الزراعية
الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي
الشعــير
المادة العلمية
د / إسماعيل عبد المنعم احمد
رئيس قسم بحوث الشعير
نشرة 714 2001
يعتبر الشعير أحد الحبوب الهامة عالميا و محليا و يحتل المركز الرابع من حيث الأهمية بعد القمح و الذرة الشامية و الأرز و تجود زراعة الشعير في الأراضي القديمة، الأراضي المطرية، الأراضي حديثة الإستصلاح و الملحية. الشعير هو محصول الحبوب الأول الأكثر إنتشارا في الأراضي المطرية بالساحل الشمالي الغربي و سيناء الشمالية و الجنوبية، و ترجع أهمية محصول الشعير في مناطق الزراعة المطرية إلي قدرته على تحمل الظروف البيئية الصعبة التي تسود تلك المناطق كما يتحمل الشعير الظروف السائدة في الأراضي الملحية.
يزرع الشعير في مصر عادة في الأراضي القديمة الضعيفة و في نهايات الترع في مساحات حوالي 80000 فدان، كذلك يزرع الشعير في الأراضي الحديثة الاستصلاح و هي أراضي إما رملية فقيرة أو أراضي متأثرة بالملوحة و تعانى نقص في مياه الري و تبلغ إجمالي المساحة في تلك المناطق حوالي 120000 فدان بينما تتركز زراعة الشعير أساسا في مناطق الزراعة المطرية و تبلغ المساحة المنزرعة حوالي 250 - 300 ألف فدان تبعا لكمية الأمطار الساقطة و توزيعها خلال الموسم.
القدرة الواسعة على الأقلمة بيئيا.
يستخدم في كثير من الأغذية الخاصة للإنسان و الحيوان.
مصدر أساسي لتغذية الأغنام بالساحل الشمالي.
يستخدم في صناعة المولت.
يجود الشعير في جميع الأراضي الزراعية سواء كانت طينية أو صفراء أو رملية أو جيرية و يفضل زراعته في الأراضي الصفراء. و يمكن للشعير أن ينمو في الأراضي الملحية و يعطى محصول إقتصادي حتى تركيز ستة آلاف جزء في المليون أملاح ذائبة سواء كان مصدر تلك الأملاح هو التربة أو مياه الري أو الإثنان معا.
القدرة الإنتاجية العالية لمحصول الحبوب و القش.
المقاومة للأمراض المختلفة خاصة أمراض التبقع و البياض الدقيقي و الأصداء.
تحمل ملوحة مياه الري و التربة.
تحمل الجفاف خاصة في حالة الزراعات المطرية في الساحل الشمالي الغربي و سيناء.
التبكير في النضج مع المحافظة على المحصول العالي.
الصفات الغذائية و التكنولوجية المرغوبة.
الملائمة لصناعة المولت.
صنف ذي ستة صفوف عالي المحصول تجود زراعته في الأراضي الجديدة و الأراضي الملحية و هو صنف واسع الأقلمة يمكن زراعته تحت ظروف بيئية متباينة.
صنف ذي ستة صفوف عالي المحصول مقاوم للأمراض تجود زراعته بالأراضي الجديدة و جنوب الوادي حيث الحرارة المرتفعة.
صنف ذي ستة صفوف يزرع في الساحل الشمالي يصلح للزراعة المطرية و يجود في المواسم متوسطة الأمطار.
صنف جديد ذي ستة صفوف أنتج خصيصا للزراعة المطرية يتفوق في حالة المواسم شديدة الجفاف و يزرع بمنطقتي الساحل الشمالي الغربي و سيناء على الأمطار.
صنف جديد من الشعير ذو ستة صفوف يتميز بالأقلمة الواسعة و أثبتت التجارب تفوقه في الزراعات المطرية على صنفي جيزة 125 و جيزة 126 كما يتفوق على صنف جيزة 123 في الأراضي الجديدة و الأراضي الملحية. و لقد بدأ في إكثاره و سوف يتم توزيعه على المزارعين بدءا من الموسم القادم. و هو صنف يمتاز بالمقاومة للإجهادات البيئية و المقاومة للأمراض.
صنف ذي صفين مبكرا يتميز بتفوقه في المحصول و مقاومته للأمراض وجودته لصناعة المولت و يصلح للزراعة بالأراضي الجديدة تحت نظام الري بالرش.
صنف ذي صفين أنتج لصناعة المولت يتفوق على صنف بونس في الأراضي القديمة و المروية بالغمر و يمتاز بمقاومته للأمراض و إرتفاع وزن الألف حبة.
تجود زراعة الشعير بعد قطن كما يمكن زراعته في أراضي الوادي كما أنه يزرع في دوره أحادية في الساحل الشمالي حيث يزرع الشعير فقط في هذه الأراضي تحت ظروف المطر.
يزرع في الأراضي المروية إبتداء من 20 نوفمبر حتى 15 ديسمبر بالوجه البحري و في الوجه القبلي من 10 نوفمبر حتى أول ديسمبر و بالنسبة للزراعات المطرية يزرع الشعير مع أول سقوط للأمطار حيث تكفى الرطوبة الأرضية لإنبات التقاوي و يجب أن تتم الزراعة مع سقوط الأمطار مباشرة حتى لا تفقد الأراضي رطوبتها بالتأخير في الزراعة. و في الساحل الشمالي الغربي تتم معظم الزراعات بعد نوة المكنسة (20 نوفمبر) و مدتها 4 أيام و قد تأتى مبكرة أو متأخرة عن هذا التاريخ بضعة أيام.
و هو الطريقة الموصى بها حيث يساعد على إنتظام توزيع الحبوب و ثبات عمق الزراعة على الحصول على نباتات متجانسة. و هذه الطريقة تفضل في حالة الأراضي المروية و تحرث الأرض مرتين متعامدتين خاصة في الأراضي الجيرية للحصول على مهد جيد لنمو البادرات و تزحف الأرض قبل الزراعة. و من مميزات هذه الطريقة توفير كمية التقاوي المستخدمة بالإضافة إلي الحصول على نباتات متجانسة النمو مع سهولة مقاومة الحشائش.
في حالة الزراعة عفير بدار يتم بذر التقاوي يدويا بانتظام في الحقل بعد خدمة الأرض ثم يتم تغطية الحبوب للحصول على نسبة إنبات مرتفعة مع مراعاة عدم زيادة عمق البذرة عن 5 سم حتى نحصل على أعلى نسبة إنبات ممكنة و تقسم الأرض بعد ذلك و يتم الري.
ينصح بإستخدام هذه الطريقة في الأراضي الموبوءة بالحشائش و فيها تروى الأرض قبل الزراعة بفترة كافية حتى يتم إنبات الحشائش ثم تحرث و هي مستحرثة و تنثر التقاوي مباشرة بعد الحرث ثم تحرث الأرض مرة أخرى متعامدة و تسوى بعد ذلك لتسهيل عمليات الري فيما بعد و تقسم الأرض لأحواض و قنوات و بتون و تترك للإنبات.
يتم حرث الأرض مرتين متعامدتين الأولى بعد إنتهاء موسم الزراعة السابق لتكسير بناء التربة في الطبقة السطحية فيقل البخر و تحتفظ التربة بقدر من الرطوبة و المرة الثانية يتم الحرث خلال النصف الأول من شهر نوفمبر لزيادة قدرة الأرض على الإحتفاظ بمياه الأمطار فلا يحدث جريان سطحي و بالتالي نحصل على مهد مناسب للزراعة المطرية. و يجرى الحرث الثالث بعد سقوط المطر الذي تكفى للإنبات و يتم نثر التقاوي مباشرة بعد المطر و قبل الحرث الأخير و لا داعي للتسوية حيث أن ضغط التربة يساعد على الجريان السطحي لمياه الأمطار بعيدا عن مناطق سقوطها فتقل نسبة الإنبات و يفضل أن يكون الحرث الثاني بعد الزراعة متعامد مع إتجاه الميل و أيضا للتغطية الخفيفة للتقاوي و أن يكون الحرث كنتورى إذا كان الميل في عدة إتجاهات.
أنسب معدل تقاوي في الأراضي المروية 5 كيلات/فدان (50 كجم/فدان) أما الزراعة المطرية 3 كيلات/فدان (30 كجم/فدان) و تزرع نثرا كما سبق ذكره.
الشعير من المحاصيل التي لها إحتياجات مائية متوسطة و ينصح برى الشعير من 2 - 3 ريات و يتوقف عدد الريات على كمية الأمطار خاصة في الوجه البحري حيث يمكن الإستعاضة عن الري إذا سقطت كمية مناسبة من الأمطار. و تعطى رية المحاياة بعد 25 يوم من الزراعة. و يجب عدم تعطيش الشعير في فترات التفريع و طرد السنابل و بدء تكوين الحبوب و هي الفترات الحرجة في حياة النبات.
بالرغم من قلة الاحتياجات السمادية لمحصول الشعير إلا أن الأسمدة و خاصة الأسمدة الآزوتية تؤدى إلي زيادة المحصول و تحسين نوعية الحبوب بشرط إضافتها في المواعيد المحددة لها.
في الزراعة المروية بالوادي ينصح بإضافة سماد فوسفاتي قبل الزراعة مباشرة بمعدل 15 كجم فو2أ5 للفدان نثرا على سطح التربة و قبل آخر حرثة ليتم تقليبها و خلطها في التربة و يضاف 100 كجم سماد فوسفاتي 15 % فو2أ5.
من المهم إضافة السماد النيتروجيني للوحدات المقررة و في المواعيد الموصى بها و لا يجب إضافة أي جرعات سماد بعد طرد السنابل و يضاف السماد الآزوتي بمعدل 45 كجم نيتروجين/فدان كما يلي :
* 100 كجم يوريا 46 % أزوت.
* أو 134 كجم نترات نشادر 5, 33 % أزوت.
* أو 218 كجم سلفات نشادر 6, 20 % أزوت.
و تقسم هذه الكمية على ثلاث دفعات :- الأولى (20 % من الكمية) عند الزراعة و الثانية (40 % من الكمية) مع رية المحاياة و تضاف الكمية المتبقية مع الرية الثانية بعد الزراعة.
و في الأراضي الرملية ينصح بزيادة معدل التسميد الآزوتي إلي 65 وحدة آزوت للفدان مع ضرورة تقسيم كمية السماد على عدد الريات إبتداء من الرية الأولى حتى طرد السنابل و هذا يساعد النبات على الإستفادة من عنصر النيتروجين دون حدوث فقد كبير من العنصر.
بالنسبة للتسميد البوتاسى فينصح بإضافة 24 كجم بو2أ/فدان من أي سماد تجارى "سلفات البوتاسيوم" للأراضي التي تحتاج لهذا العنصر.
و ينصح بعدم إستخدام اليوريا في الأراضي الرملية أو الأراضي الملحية حيث يوصى بإستخدام نترات الأمونيوم في الأراضي الملحية. و في الزراعات المطرية فلا يسمد الشعير بالسماد الآزوتي إلا في حالة التأكد من سقوط الأمطار مع وجود كمية من الرطوبة تكفى لإذابة كمية السماد المضافة.
في الأراضي المروية يتم إتباع الزراعة الحراتى في الأراضي الموبوءة بالحشائش و ذلك عن طريق إعطاء رية قبل الزراعة بوقت كاف للتخلص من الحشائش التي تنمو على هذه الرية و ذلك بحرث التربة و هي مستحرثة.
* المقاومة الكيماوية للحشائش الحولية عريضة الأوراق
تتم المقاومة كيماويا برش الحشائش الحولية العريضة بمبيد البرومينال 24 % E C بمعدل 1 لتر للفدان و الشعير في عمر 3 - 4 أوراق أو الجرانستار 75 % D F بمعدل 8 جم/فدان مبكرا بعد إكتمال إنبات الشعير.
تتغذى هذه الحشرة على منطقة إتصال الساق بالجذر حيث تسبب جفاف النبات و سهولة موته و أهم أعراض الإصابة بهذه الحشرة هو ذبول النبات و سهولة خلعه من التربة ثم وجود الأنفاق بالتربة أسفل سطح التربة. و يجب مقاومة هذه الحشرة فور ظهور أعراضها و ذلك بإستعمال طعم سام يتكون من :
مسحوق الهوستاثيون 40 % قابل للإستحلاب بمعدل 25, 1 لتر للفدان + 15 كيلو جرام جريش ذرة مبلل بالماء و ينثر الطعم السام قبل الغروب مع التركيز على المناطق القريبة من المراوى و المصارف.
تصاب نباتات الشعير بالعديد من أنواع المن مثل من الذرة الشامية و من الشوفان و من القمح الأخضر و من الغلال الإنجليزي بالإضافة إلي العديد من الأنواع الأخرى و يأتي من الذرة الشامية في المقدمة من حيث خطورته على الشعير و تسبب حشرة المن خسائر كبيرة في المحصول و تزداد الإصابة بحشرة المن في مناطق مصر الوسطى و مصر العليا و تهاجم الحشرة الأوراق و السيقان لنبات الشعير حيث تمتص العصارة من أنسجة النبات و تسبب الإصفرار و الذبول كما تسبب الندوة العسلية في حالة الإصابة الشديدة تكوين حبوب غير ممتلئة و بالتالي
و من الممكن إستخدام بدائل المبيدات بأمان على الشعير و قصر الحاجة بإستخدام المبيدات التقليدية في حالات الإصابة الوبائية فقط. على أن يتم المرور على الحقول عقب ظهور البادرات بثلاثة أسابيع و بصفة دورية و من البدائل المقترحة لعلاج إصابات الشعير بحشرات المن :
زيت سوبر مصرون 94 % مستحلب بمعدل 1 لتر/100 لتر ماء.
زيت سوبر رويال 95 % مستحلب بمعدل 1 لتر/100 لتر ماء.
زيت ك زد أويل 95 % مستحلب بمعدل 1 لتر/100 لتر ماء.
ديتر جنت سائل 5, 1 لتر/100 لتر ماء.
* و يستخدم أحد المبيدات التقليدية الآتية في حالة الإصابة الوبائية :
الملاثيون 75 % مستحلب يمعدل 150 سم3/10 لتر ماء.
سوماثيون 50 % مستحلب يمعدل 250 سم3/100 لتر ماء.
و ذلك كعلاج للبؤر المصابة فقط و لا ينصح بالإنتظار للتعامل مع الإصابة رش عام بل يجب معالجة البؤر المصابة التي تظهر أول بأول.
من أهمها الأصداء و التبقع الشبكي و البياض الدقيقي و كذلك مرض التفحم السائب و المغطى.
تظهر الأعراض على هيئة بقع مسحوقية (بثرات) لونها بنى فاتح مستديرة مبعثرة بدون نظام على الأوراق و كذلك على أغماد الأوراق. و في نهاية الموسم تتحول هذه البثرات إلي اللون الأسود. يناسب المرض درجة حرارة متوسطة نسبيا (15 - 22 ° م) و درجة رطوبة عالية و يسود في مناطق شمال الدلتا و منطقة النوبارية و بعض مناطق الساحل الشمالي و يقاوم المرض عادة بإستنباط أصناف مقاومة و هناك عديد من الأصناف المقاومة في برنامج التربية.
يظهر المرض على هيئة بقع مغزلية الشكل حولها هالة صفراء و بها تقسيم شبكي من الداخل (n et type) كما يظهر أحيانا على هيئة بقع صغيرة مستديرة حولها هالة صفراء (s pot type).
و تظهر الإصابة عادة أولا على الأوراق السفلي ثم تمتد لأعلى. يناسب هذا المرض درجة حرارة منخفضة نسبيا(6 - 15 ° م) و ينتشر أكثر على الأصناف ذو الصفين. ينتشر في مناطق شمال الدلتا - الأراضي الجديدة بالنوبارية - الساحل الشمالي (خاصة في السنوات الممطرة).
يقاوم المرض بإستخدام أصناف مقاومة و من الممكن إستخدام المقاومة الكيماوية خاصة عند بداية ظهور الإصابة.
تظهر أعراض الإصابة على الأوراق و السيقان و السنابل على هيئة بقع بيضاء غير منتظمة و تتحد مع بعضها و يكون لها ملمس دقيقي و يتحول اللون إلي الرمادي بتقدم الإصابة يحدث إصفرار للأوراق فيظهر بها نقط سوداء في حجم رأس الدبوس.
و لمقاومة المرض يجب إستخدام التقاوي المعتمدة للأصناف الموصى بها و إستخدام مبيد سابرول عند ظهور بقع الإصابة.
تظهر الإصابة الأولية على البادرات الناتجة من حبوب مصابة على هيئة خطوط باهته بطول الورقة ثم تتحول إلي اللون البني بتقدم الإصابة و يحدث تقطيع طولي للورقة. تصاب الأوراق القديمة أولا ثم الحديثة و هكذا.. أي أن الإصابة تعم النبات حتى السنابل. تنتقل الإصابة عن طريق الحبوب الملوثة بجراثيم الفطر من العام الماضي أو من مخلفات المحصول السابق. تنتشر الإصابة بهذا المرض في أراضي الزراعات المطرية بالساحل الشمالي و كذلك في جميع مناطق زراعة الشعير بالأراضي الجديدة و أراضي الوادي.
يقاوم المرض بإستخدام تقاوي معتمدة للأصناف الجديدة و من الممكن إستخدام بعض المبيدات الجهازية لمعاملة التقاوي.
تظهر أعراض الإصابة عند طرد السنابل فيظهر محور السنبلة مغطى تماما بمسحوق أسود من جراثيم الفطر التي تتطاير نتيجة إهتزاز النباتات بفعل الرياح أو غيرها و بعد فترة يظهر محور السنبلة فقط و هو عار تماما نتيجة تطاير جراثيم الفطر و سقوطها على مياسم الأزهار القابلة للإخصاب ثم تنبت الجرثومة و تسلك نفس سلوك حبة اللقاح حتى تصل المبيض و تسكن جرثومة الفطر بجوار الجنين و بعد الحصاد و الدراس لا تظهر على الحبوب أي أعراض مرضية و عند زراعة الحبوب المصابة في الموسم التالي ينشط الفطر و ينمو داخل النبات و يلازم القمة اللنامية للنبات و عند تكوين السنبلة تتكون جراثيم الفطر مكان الحبوب و التي تظهر كمسحوق أسود عند تكشف السنبلة لتعيد دورة الحياة و عادة ما تظهر السنابل المصابة قبل السليمة بحوالي يومين.
لمقاومة المرض يجب إستعمال تقاوي معتمدة أو معاملة التقاوي بمبيد S umi-8 بمعدل 3 جم/كجم تقاوي مع الخلط الجيد.
تظهر أعراض الإصابة عند طرد السنابل فيظهر محور السنبلة و به جراثيم الفطر مكان الحبوب و مغطاة بغلاف رقيق. و عند الدراس تختلط الجراثيم بالحبوب و تلوثها و عند زراعة الحبوب الملوثة يخترق الفطر البادرة و يدخل داخل النبات و يلازم القمة النامية كما في التفحم السائب أي أن الإصابة هنا تحدث للبادرة و ليس للحبوب أثناء تكوينها.
تظهر الأعراض على هيئة بقع بنية في قمة الأوراق ثم يظهر على الحواف من أعلى إلي أسفل و في بعض الحالات تظهر هذه البقع على الورقة كلها. و تصاب الأوراق القديمة أولا ثم الحديثة.. و هكذا حتى تعم الإصابة جميع أجزاء النبات. تنتشر الإصابة بهذا المرض في مناطق الساحل الشمالي و في بعض مناطق الأراضي الجيرية بالأراضي الجديدة.
يقاوم المرض بزراعة أصناف لها القدرة على تحمل التركيزات العالية من البورون في التربة مثل الصنف جيزة 124.
و فيه تتلون قمة أوراق النبات باللون الأصفر أو القرمزي و يكون النبات متقزما و يؤدى المرض إلي نمو غير طبيعي للنبات حيث يقل عدد الاشطاء و في حالة الإصابة الشديدة ينعدم المحصول تقريبا و تنتقل الإصابة عن طريق حشرة المن.
يبدأ حصاد الشعير في نهاية شهر إبريل و أوائل شهر مايو و يوصى بعدم التأخير في الحصاد حتى لا يتعرض المحصول للفرط بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لزراعة المحاصيل الصيفية في الوقت الملائم و يتم حصاد الشعير بعد تمام نضج المحصول و من علامات النضج إصفرار النباتات و صلابة الحبوب و سهولة فرك السنابل. و تتم عملية الحصاد بتقطيع السيقان فوق سطح الأرض يدويا بواسطة المنجل و آليا بإستخدام آلات الحصاد. هذا و يفضل إستخدام الآلات في عملية الحصاد و الدراس و التذرية حيث تؤدى إلي تقليل الفاقد من محصول الشعير.
يجب أن تجف الحبوب قبل تخزينها بحيث لا تزيد نسبة الرطوبة عن 13 %.
تخزن الحبوب في مخازن جيدة التهوية حتى لا تتعرض الحبوب لآفات الحبوب التي تنشط في حالة التخزين غير الجيد.
لما كان محصول الحبوب يتحدد بثلاث مكونات هي (عدد السنابل في وحدة المساحة، عدد حبوب السنبلة و متوسط وزن الحبة) فإن أي عملية زراعية ترفع من قيمة واحد أو اكثر من هذه المكونات لأنها تؤثر بالإيجاب على محصول الحبوب.
يتأثر تفريع النبات و دليل التفريع (نسبة عدد السنابل إلي عدد الفروع الكلية) بالظروف البيئية المحيطة، فيتأثر بنوع التربة و قوامها و قدرتها على حفظ الماء و ملوحتها و ملوحة مياه الري و يؤثر ميعاد الزراعة على تفريع النبات حيث أن التفريع العالي يتم في الفترة من 18 - 28 يوم من عمر النبات و التبكير أو التأخير عن الميعاد المناسب يجعل فترة التفريع إما في فترة تزيد فيها حرارة الجو أو تقل عن الدرجة المثلى و يؤثر هذا على النظام الأنزيمي الذي بدوره يؤثر على عملية التفريع كما تؤثر عمليات خدمة الأرض قبل الزراعة على التفريع عن طريق تأثيرها على قدرة حفظ الأرض للماء خاصة تحت نظام الزراعة المطرية و بالتالي يتأثر عدد السنابل في وحدة المساحة، و كلما زاد معدل التقاوي عن الحد الأمثل زادت المنافسة بين النباتات على المياه و العناصر الغذائية فيقل عدد السنابل في وحدة المساحة كما أن الإجهاد المائي للشعير في طور التفريع الفعال (عند عمر 18 - 25 يوم من الزراعة) يؤثر تأثيرا كبيرا على عدد فروع النبات و عدد سنابله و الإجهاد المائي في فترة طرد السنابل يؤثر على عدد السنابل في وحدة المساحة و يؤثر نقص التسميد بالعناصر الغذائية الكبرى (آزوت، فوسفور، بوتاسيوم) على عدد السنابل في وحدة المساحة و ينخفض عدد السنابل في وحدة المساحة بالأراضي الموبوءة بالحشائش.
يتأثر عدد حبوب السنبلة بالظروف البيئية المحيطة فيتأثر بميعاد الزراعة حيث أن التقديم أو التأخير في ميعاد الزراعة يجعل تكوين أصول السنابل في فترة غير مناسبة فيتأثر عدد السنيبلات بدرجات الحرارة السائدة و يؤثر الإجهاد المائي و الغذائي على تكوين أصول السنابل و بالتالي عدد سنيبلات السنبلة و يؤثر الإجهاد المائي في فترة طرد السنابل و الإزهار على عدد السنيبلات الخصبة و بالتالي عدد حبوب السنبلة.
تؤثر العمليات الزراعية على وزن الحبة، فخدمة الأرض قبل الزراعة يرفع من قدرتها على حفظ الماء و تهوية التربة مما يؤدى لتكوين نمو خضري جيد ينعكس على حجم ووزن الحبة. كما تؤثر درجة ملوحة التربة و مياه الري على حجم ووزن الحبة. يؤثر ميعاد الزراعة على التبكير أو التأخير في ميعاد طرد السنابل، فإن صادف طرد السنابل إرتفاع في حرارة الجو فإن ذلك يؤدى إلي ضمور الحبوب نتيجة زيادة فقد الماء من الأرض بالبخر و من النبات بالنتح و تقل العصارة الغذائية بالأنسجة و يقل إنتقال نواتج عملية التمثيل الضوئي للحبوب. و الإجهاد المائي أثناء فترة إمتلاء الحبوب الناتج عن نقص الرطوبة الأرضية لتأخير الري أو عدم سقوط الأمطار ينتج عنه حبوب ضامرة و يقل وزن الحبة.
و عموما فإن إدراك أخصائي الشعير و الفنيين العاملين في حقول إنتاج محصول الشعير بإرتباط العمليات الحيوية داخل النبات بالعمليات الزراعية أمر ضروري حتى يقوموا بدورهم بتوعية المزارع على أسس سليمة.