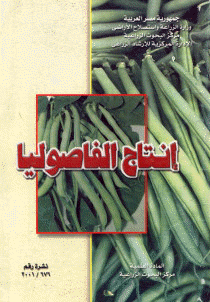
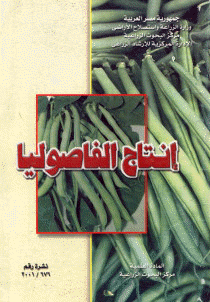
جمهورية مصر العربية
وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي
مركز البحوث الزراعية
الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي
|
المادة العلمية |
أ.د. فايق ساوبرس أ.د. صفوت عزمي دوس د. سميرة الجيزى أ.د. وجيه يسرى رياض أ.د. يحيى سالم خفاجي |
معهد بحوث البساتين معهد بحوث وقاية المزروعات معهد بحوث البساتين معهد بحوث البساتين معهد بحوث أمراض النباتات |
676 سنة 2001 |
تعتبر الفاصوليا من أهم محاصيل العائلة البقولية و تتميز بنموها الجيد في المناطق المعتدلة و تزرع بغرض استهلاك القرون الخضراء أو البذور الخضراء و الجافة سواء للتسويق المحلى أو التصدير.
و تصدر مصر ما يقرب من 12 ألف طن فاصوليا سنويا و يبدأ موسم التصدير من أول أكتوبر حتى نهاية شهر يونيو و قد كانت مصر تزرع الفاصوليا السميكة القرون فقط و أصبحت الآن بعد توصيات معهد بحوث البساتين تزرع الأصناف متوسطة السمك ذات الكفاءة الإنتاجية العالية و تحتل مصر المرتبة الرابعة من حيث إنتاجية الفدان .
و تهدف الخطة الحالية لمعهد بحوث البساتين للارتفاع بإنتاجية الفدان لتغطى احتياجات السوق المحلى لزيادة متوسط استهلاك الفرد من الفاصوليا الخضراء، أما الفاصوليا الجافة فان معهد بحوث البساتين لديه الكثير من الأصناف التي يمكن أن تعرض جزئيا النقص في انخفاض كميات الفول البلدي و أيضا التوسع في عملية تصدير الفاصوليا الجافة نظرا لملائمة مواصفات البذور الجافة مع متطلبات التصدير و تمثل مصر الدولة الثانية من حيث إنتاجية الفدان من الفاصوليا الجافة .
و يسر الإرشاد الزراعي بالاشتراك مع معهد بحوث البساتين أن يقدم هذه النشرة لزراع الفاصوليا متضمنة أهم التوصيات و الإرشادات التي تعينهم في أداء كافة العملياتالزراعية بكل دقة حتى يحققوا أعلى إنتاجية من هذا المحصول .
1 - الملوحة 2 - نسبة الكالسيوم 3 - مستوى الماء الأرضي
لا تتحمل نباتات الفاصوليا أي نسبة بسيطة من الملوحة في الماء و أيضا لا يمكن أن تتحمل أي نسبة ملوحة بالتربة حيث أن ملوحة التربة أحد العوامل الرئيسية في نجاح زراعة الفاصوليا و بالرغم من تباين عناصر ملوحة التربة أي أن هذه الملوحة قد تكون متسببة من عناصر مختلفة إلا أنها جميعها ضارة بالفاصوليا إذ أن ارتفاع ملوحة التربة عن 5, 1 ملليموز يتسبب عن فشل الزراعة و بالطبع هذا و يتوقف جودة القرون الخضراء إلي انخفاض نسبة الملوحة إلي اقل حد ممكن حيث أن ارتفاع نسبة الملوحة يتسبب في فقد هذه الجودة و تصبح القرون غير صالحة للاستهلاك الأخضر و في النسب البسيطة من الملوحة (5, 0 – 0, 1 ملليموز) يجب الاحتراس في عملية العزيق حيث أن هذه العملية تتسبب في بعض الأحيان في تركيز الأملاح حول الجذور و كذلك يجب التنبيه إلي أن الزراعة يجب أن تتم في الثلث السفلي من الخط و لا يتغير مكان النبات بالعزيق .
و عموما لا يفضل للزراعة الناجحة الاقتصادية أي نسبة من الملوحة في التربة .
ارتفاع نسبة الكالسيوم تتسبب أيضا في عدم نجاح الفاصوليا و من المعروف أن اليوسفي و الفاصوليا من المجموعة الحساسة لارتفاع نسبة الكالسيوم في التربة حيث أن زيادة هذا العنصر تعمل على انخفاض جودة المحصول و كذلك كميته لذا يجب الزراعة في الأراضي الخالية من الكالسيوم، و اغلب الأراضي التي بها نسبة عالية من الكالسيوم تتركز في بعض البقع بالنوباري .
لان الفاصوليا حساسة لكمية الماء عامة فان ارتفاع مستوى الماء الأرضي يتسبب عنه عدم نجاح الزراعة و لذا فوجود مصارف عامل هام من عوامل نجاح زراعة الفاصوليا و لا يمكن تقليل تأثير ارتفاع مستوى الماء الأرضي بتقليل عدد الريات لان وجود الماء قريب من جذور النباتات دائما يعمل على الاختناق الفسيولوجى و كذلك يعمل على زيادة الأمراض الفطرية اللاهوائية بالتربة و يمكن التقليل الجزئي لهذا الخطر و ذلك بزيادة مرات العزيق في الفاصوليا إلي حد ما .
كذلك يفضل في اختيار الأرض المناسبة لزراعة الفاصوليا أن لا تكون قلوية اكثر من اللازم إذ من المعروف أن اغلب أراضي الجمهورية تميل إلي 2 , 7 PH لذا لا يجب التجاوز و الزراعة في أراضي بها درجات قلوية أعلى من ذلك، و مع ذلك ينصح دائما باستخدام الأسمدة الحامضية لزيادة المحصول في حالة ارتفاع القلوية.
كذلك لا تنجح زراعة الفاصوليا في الأراضي المستصلحة حديثا ذات حبيبات التربة الخشنة حيث أن تذبذب الماء بهذه الأراضي يؤثر تأثيرا بالغا على نجاح المحصول لذا يفضل في الأراضي المستصلحة حديثا الحبيبات الناعمة المتماسكة قليلا و لا تفضل التربة الطفلية و هي منتشرة انتشارا كبيرا في الأراضي المستصلحة حيث أن هذه التربة تجف من السطح العلوي و لكنها تبقى محتفظة بالماء فترة طويلة من السطح السفلي مما يعرض النباتات للخطر بالإضافة إلي تماسك هذه التربة حول جذور النباتات يقلل من سرعة نمو الجذور و بالتالي النمو الخضري و إذا كانت الأرض بها نسبة قليلة من الطفلة فيجب علاجها بالأسمدة البلدية و الفوسفاتية و الجبس الزراعي حتى تتفكك و تصبح صالحة لزراعة الفاصوليا .
الدورة الزراعية إن كانت هامة في زراعة كل المحاصيل لكنها في الفاصوليا اكثر أهمية نظرا لحساسية الفاصوليا للتغذية و أيضا للأمراض الفطرية في التربة حيث انه من آثار عدم اتباع دورة زراعية جيدة أن يختل توازن بعض العناصر الصغرى بالتربة و يزداد انتشار كثير من أمراض التربة .
و إن كانت الآراء تختلف ما بين اتباع دورة زراعية ثلاثية أو خماسية إلا انه من الضار جدا عدم اتباع أي دورة زراعية كما هو حادث الآن بأغلب المساحات بمصر و الأغلبية تفضل اتباع الدورة الزراعية الثلاثية بمعنى عدم زراعة أي محصول بقولي إلا كل 3 سنوات في ذات البقعة (الأرض)، لذا فان من الأخطاء الشائعة زراعة فاصوليا فى ارض سبق زراعتها بالفول أو العدس مثلا و تعمل اتباع الدورة الزراعية الجيدة إلي عدم انتشار الأمراض خاصة أمراض التربة الفطرية و تحسين تغذية الفاصوليا التي لا يمكن أن تعوضها الأسمدة المضافة صناعيا للنبات و أيضا لا يفضل زراعة فاصوليا بعد أرز إلا بعد الخدمة الجيدة للمحصول السابق و تعريض التربة للشمس فترات طويلة و تنجح جيدا زراعة الفاصوليا بعد بطاطس أو نباتات العائلة القرعية و كذلك الباذنجانيةو الذرة .
مواعيد الزراعة تزرع الفاصوليا على مدى واسع من مواعيد الزراعة و ذلك تبعا للغرض المنزرعة من اجله و على العموم لا تتحمل الفاصوليا ارتفاع درجات الحرارة عن 34 °م لأنها تؤدى إلي عدم نجاح عقد القرون و تكوين الثمار كذلك إذا انخفضت عن 10° م تقريبا .و درجات الحرارة المناسبة للعقد و التزهير تتراوح ما بين 15 – 25 °مو نظرا لتباين الأجواء بمصر فان هناك بعض المناطق التي ممكن أن تزرع في مواعيد مختلفة.
الزراعة لغرض السوق المحلى هي التي تعطى أعلى إنتاجية و يتم ذلك في عروتين العروة الصيفي في نصف فبراير و قد تمتد إلي أول مارس في الوجه البحري و العروة الخريفية من آخر أغسطس إلي أوائل سبتمبر .
الغرض من الزراعة للتصدير الأخضر هو توافر القرون الخضراء طوال الوقت المطلوبة للتصدير حتى يكون هناك إنتاج عالي الجودة بقدر الإمكان من أكتوبر حتى يونيو لذا لكل منطقة في الجمهورية ميعاد متميز لها .
و عموما اختيار الصنف المناسب للعروة المناسبة أمر هام للغاية.
تتم زراعة المحصول الجاف في العروتين الأساسيتين لزراعة الفاصوليا و هي العروة الصيفي في نصف فبراير و يجب عدم التأخير عن أول مارس حتى لا تكون درجات الحرارة المرتفعة السائدة خلال شهر إبريل و مايو تقلل من العقد أو تسبب صغر وزن البذور الجافة كذلك تتم الزراعة خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس و الأول من شهر سبتمبر كعروة خريفية و يجب أيضا عدم التأخير عن هذه المواعيد لكي لا تتسبب درجات الحرارة المنخفضة في شهر ديسمبر في انخفاض نسبة العقد أو عدم النضج الكافي للبذور و بالتالي انخفاض المحصول .
الحرث و الحرث العميق الذي يصل إلي 20 – 25 سم من المهم جدا في زراعة الفاصوليا حيث أن جذور الفاصوليا بالرغم من أنها تعتبر سطحية إلا أن تفكك حبيبات التربة هام جدا في القضاء أو انخفاض نسبة الأمراض الفطرية بالتربة و الحرث يتم مرتين متعامدين على بعضهما و يجب إضافة الأسمدة البلدية و الكيماوية قبل الحرث و ذلك لضمان التوزيع الجيد .
يوضع 20م3 من السماد البلدي الجيد المتحلل لكل فدان من أراضي وادي النيل و تخفض الكمية إلي النصف في حالة الزراعة بعد البطاطس حيث يتم تسميد البطاطس و الذرة بكميات كبيرة من السماد البلدي تفيد نباتات الفاصوليا و يجب الاحتراس في إضافة السماد البلدي حتى لا يعمل على نقل أمراض أو حشائش فيجب أن يكون قديم و متحلل في مكمورة و في الأراضي الخصبة القديمة يمكن خفض كمية السماد البلدي إلي 10م3 فقط .
نظرا لان محصول الفاصوليا سريع النمو و النضج فان إضافة بعض الأسمدة الكيماوية في التربة قبل الزراعة يكون مفيد في سرعة الاستفادة منها و يضاف ما يلي :
1 – 50 كجم كبريت زراعي و ذلك كمغذى و كخافض طفيف للحموضة و يعمل على ذوبان كثير من العناصر التي تحتاجها الفاصوليا .
2 – 200 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم الأحادي حيث انه قد يكون بطيء الذوبان لذا يحتاج إلي فترة حتى يتم الاستفادة منه .
3 – 100 كجم سلفات نشادر و هذه الكمية نصف ما تحتاجه الفاصوليا تقريبا على أن يوضع النصف الآخر بعد الزراعة .
4 – 50 كجم سلفات بوتاسيوم و هي كل الكمية التي تحتاجها الفاصوليا تقريبا .
و بعد وضع السماد و الحرث و التزحيف الجيد تخطط الأرض بمعدل 11 خط/قصبتين للزراعة سواء للفاصوليا الخضراء أو بمعدل 12 خط/قصبتين للفاصوليا الجافة و في الأراضي الجيدة الخالية من الحشائش و يمكن زراعة الفاصوليا الجافة على الريشتين بمعدل 10 خطوط / قصبتين و تقسم بعد ذلك إلي فرد عرض الفردة يتحدد بمقدار استواء الأرض ففي الأراضي المستوية بأشعة الليزر يمكن أن يكون عرض الفردة 15 – 20 م لسرعة تحرك ماء الري أما الأراضي الأقل استواء ينخفض عرض الفردة إلي النصف أو الربع و تروى الأرض للزراعة الحراتى .
فانه يلزم حرث الأرض كلها جيدا مرتين متعامدتين ووضع السماد البلدي بمعدل 30م3 للفدان سماد حيواني أو 15م3 سماد كتكوت مع 50 كجم كبريت زراعي مع 200 كجم سوبر فوسفات مع 50 كجم سلفات بوتاسيوم و لكن يفضل وضعها في الأرض كلها في حالة الزراعة اليدوية تخطط الأرض بمعدل 12 خط/قصبتين للزراعة للمحصول الأخضر أو الجاف على ريشة واحدة أو 11 خط/قصبتين للزراعة للمحصول الجاف على ريشتين في حالة عدم وجود حشائش هذا في الزراعة اليدوية. أما في الزراعة بالآلات PLANTTER فان الأرض بعد التسميد و الحرث و التزحيف لا تخطط حتى تتمكن الآلات من الزراعة و تضبط الماكينات للزراعة بمسافات 60 سم × 75 سم.
و عموما في حالتي الري بالرش و التنقيط في الأراضي المستصلحة حديثا أو الرملية يمكن الزراعة بالطريقة العفير و ليست بالحراتى .
في القديم كانت تتم الزراعة في جور لكن أثبتت الأبحاث الحديثة أن الزراعة في جور لا تعطى فرص متساوية لكل نبات مقارنة بالنبات الآخر و لذلك تفضل الزراعة سرسبة أي سبحية أو في سطور و يتم ذلك في كل الحالات بعد الري و الجفاف المناسب (حيراتى) بفتح منتصف الخط بالفؤوس الفرنسية الضيقة ثم تسرسب البذور أو تلقط بين كل بذرة و أخرى 5 سم و تكون مثل السبحة و لذلك سميت سبحية و أن لا تكون البذور متلامسة أو متباعدة ثم تغطى بالتراب المندى ثم الجاف و من الأهمية أن لا يزيد سمك الغطاء عن 3 سم في أراضي وادي النيل لان زيادة الغطاء عن الحد المناسب يعمل على تأخير الإنبات و يعمل على انتشار بعض الأمراض الفطرية أما في الأراضي الرملية فانه تحت نظم الري الحديثة (تنقيط – رش) يمكن الزراعة عفير و أن يكون سمك الغطاء 5 سم .
يقصد بالتلقيح البكتيري معاملة التقاوي قبل الزراعة بمستحضر العقدين الخاص بالمحصول البقولى، حيث يحتوى العقدين على بكتيريا العقد الجذرية و التي يمكنها تكوين أو زيادة تكوين العقد الجذرية على جذور النباتات البقولية حيث تقوم العقد الجذرية المتكونة بتثبيت الازوت الجوى و إمداد النباتات باحتياجاتها من الازوت و يؤدى ذلك إلي توفير كميات كبيرة من السماد الآزوتي تصل إلي حوالي 60 كجم ازوت للفدان (200 كجم نترات نشادر أو 130 كجم يوريا في حالة التلقيح البكتيري الناجح)، كما يؤدى التلقيح البكتيري إلي زيادة محصول الحبوب و تحسين نوعيتها من حيث حجم الحبوب و امتلائها و بالتالي يزداد محتوى التربة من المواد الآزوتية فتستفيد المحاصيل التالية للمحصول البقولى و يمكن الحصول على العقدين من معامل وحدة إنتاج الأسمدة الحيوية بمعهد الأراضي و المياه بالجيزة أو المعمل البكتيري بمحطة البحوث الزراعية بسخا/محافظة كفر الشيخ .
و عموما ينصح بمعاملة تقاوي الفاصوليا بالعقدين قبل الزراعة مباشرة و خاصة في الحالات الآتية :
1 – عند الزراعة في الأراضي الجديدة أو المستصلحة حديثا و ذلك لخلو هذه الأراضي من بكتيريا العقد الجذرية الفعالة اللازمة لتكوين العقد الجذرية و في هذه الحالة ينصح بتلقيح تقاوي الفدان بمعدل 2 كيس عقدين (400 جم) .
2 – عند زراعة الفاصوليا في ارض لم يسبق زراعتها بهذه المحاصيل مهما بلغت درجة خصوبتها .
3 – عندما تطول الفترة بين زراعة المحصول البقولى مرتين متتاليتين في دورة زراعية أو اكثر. و عموما فان تكرار تلقيح التقاوي عند كل زراعة تضمن توفير السماد الآزوتي و زيادة المحصول .
4 – لتعويض نقص محتوى التربة في عدد بكتيريا العقد الجذرية أو قلة فاعليتها نتيجة لتعرض التربة للجفاف أو زيادة الرطوبة أو ارتفاع مستوى الماء الأرضي و استخدام المبيدات .
1 – العبوة تحتوى على 200 جم تكفى لتلقيح تقاوي فدان واحد و يلاحظ أن لكل محصول بقولي العقدين الخاص به و يجب مراعاة عدم استخدام لقاح من العام السابق أو لقاح مضى على إنتاجه اكثر من ثلاثة اشهر و في حالة التخزين لحين الاستعمال يراعى أن يتم ذلك بعيدا عن الحرارة أو الشمس المباشرة و بعيدا عن الكيماويات و الأسمدة .
2 – تذاب 2 – 3 ملعقة سكر في 5, 1 كوب ماء و يقلب حتى الذوبان ثم تخلط محتويات كيس العقدين مع المحلول السكري السابق تجهيزه .
3 – توضع التقاوي المراد تلقيحها على فرشة نظيفة من البلاستيك و يوزع عليها مخلوط العقدين و السكر و يقلب جيدا مع التقاوي حتى تغطى كل التقاوي بالعقدين، على أن يتم ذلك في مكان مظلل بعيدا عن الشمس .
4 – تترك التقاوي المعاملة بالعقدين لتجف في الظل لمدة حوالي ساعة ثم تزرع فورا و يجب ألا تترك التقاوي المعاملة بالعقدين لمدة تزيد عن ساعة قبل زراعتها .
5 – تروى الأرض بعد زراعتها مباشرة في حالة الزراعة العفير .
في حالة استخدام المطهرات الفطرية يستخدم العقدين بالطريقة الآتية:
1 – تخلط التقاوي بالمطهر الفطري و تزرع في الحقل .
2 – يخلط 3 – 4 كيس من العقدين (600 – 800 جم) بحوالي 50 كجم رمل ناعم أو تربة ناعمة (لكل فدان) منداه بالمياه و تخلط جيدا .
3 – يسرسب مخلوط العقدين و التربة بجوار جور الزراعة و يغطى بالتربة ثم الري و تستخدم هذه الطريقة في حالة انتشار الفطريات المرضية في التربة .
4 – يكشف عن نجاح التلقيح البكتيري بعد حوالي 4 أسابيع من الزراعة و ذلك بخلع عدد من النباتات بالجذر من أماكن متفرقة من الحقل و بفحص المجموع الجذري فإذا وجد اكثر من 10 عقد جذرية ذات لون احمر من الداخل يعتبر التلقيح ناجحا و يلاحظ أن زيادة التسميد الآزوتي يؤدى إلي عدم تكوين العقد الجذرية و عدم فاعليتها .
تختلف كمية التقاوي باختلاف الصنف و طبيعة التربة فبالنسبة للصنف يختلف تبعا لوزن البذور و تبعا للغرض من الزراعة و عموما للحصول على أعلى محصول { 80 ألف نبات في حالة المحصول الأخضر و إلي 120 ألف نبات في حالة المحصول الجاف} نحتاج إلي 24 كجم تقاوي صنف برونكو أما تقاوي صنف تارينا فإنها اقل وزنا من البرونكو فتحتاج إلي 22 كجم تقاوي فقط و هذا الصنفان للمحصول الأخضر، أما للمحصول الجاف فنحتاج إلي 35 كجم من الصنف جيزه 6 حيث أن وزن مائة بذرة 41 جم بينما في الصنف بنرسيكا نحتاج إلي 40 – 45 كجم تقاوي لكل فدان نظرا لان وزن مائة بذرة تصل إلي 52 جم.
و يفضل زيادة أعداد التقاوي و بالتالي النباتات في حالة الأراضي الرملية و كذلك تحتاج نظم الري الحديثة لإعداد نباتات اكبر نظرا لان الفدان لا يقسم إلي قني و بتون.
الفاصوليا من المحاصيل الحساسة جدا للري و تحتاج في أراضي وادي النيل إلي 4 – 5 ريات فقط و يفضل الري السريع على الحامي في الصباح الباكر أو المساء و عموما كميات قليلة جدا من المياه على فترات متفاوتة افضل بكثير من كميات كبيرة من المياه على فترات متباعدة.
بالنسبة لأول ريه في أراضي وادي النيل يفضل تأخيرها إلي أقصي حد ممكن فيمكن أن تكون بعد 21 يوما حتى تعطى فرصة لتعمق الجذور و بالتالي تحمله لعمليات جمع المحصول الأخضر و هروبه من الأمراض الفطرية بالتربة أما في الأراضي الرملية فان الزراعة تكون في الغالب عفير تحت نظم الري الحديثة و الري يكون بكميات قليلة لكنها كل 1 – 3 يوم تبعا للمناخ و طبيعة التربة حتى تكامل الإنبات ثم تطول الفترة بين الريات نوعا حتى التزهير و يعطى للنبات كميات اكبر من المياه أثناء العقد و لكنها في فترات متقاربة أيضا حتى لا يحدث اختلال كبير في المياه المتوفرة في التربة الرملية مما يعمل على التواء القرون و في حالة المحصول الجاف يفضل إعطاء المياه حتى يبدأ النبات في الاصفرار.
ليس الغرض من العزيق التخلص من الحشائش فقط و لكن في تهوية التربة حول الجذور و تقليل فاعلية الأمراض الفطرية في التربة و كذلك تهيئة الجذور للتعمق إلي اسفل لذا يجب عزيق النباتات مرتين على الأقل الأولى في أراضي وادي النيل بعد 15 – 17 يوم يتبعها ترك الأرض للتشميس عدة أيام ثم التسميد و الري، و الثانية بعد الأولى بحوالي أسبوعين قبل أن تتشابك النباتات و في كل مرة من العزيق يتم نقل جزء من الريشة البطالة إلي العمالة لتصبح النباتات في النهاية في منتصف الخط.
أما في الأراضي الرملية تحت نظم الري الحديثة فيتم خربشة التربة حول النباتات و خاصة إذا كانت هناك مناطق منخفضة تتجمع فيها المياه فيجب خربشتها بصفة دورية لذا يفضل تحت نظم الري الحديثة دائما تخطيط الأرض بالمعدلات المذكورة سابقا حتى يعمل قاع الخط على سحب المياه الزائدة و لذلك لابد من العزيق لتصبح النباتات في وسط الخط أو لتهوية الجذور.
تحتاج الفاصوليا في أراضي وادي النيل إلي 40 وحدة ازوت، 40 وحدة فوسفور، 20 وحدة بوتاسيوم و لما كان الفوسفور في صورة سوبر فوسفات و كذلك سلفات البوتاسيوم تحتاج إلي فترة ذوبان و تحلل لكي يتمكن النبات من امتصاصها فيجب إضافة هذه الأسمدة مبكرا أما الازوت في صورة سلفات النشادر و هي الصورة المفضلة للفاصوليا فانه يقسم على الأطوار الفسيولوجية لعمر النبات فبالإضافة إلي ما تم وضعه قبل الزراعة فيوضع عند الرية الأولى 50 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم مع 50 كجم سلفات النشادر و يوضع 50 كجم سلفات نشادر أخرى عند التزهير.
أما تحت نظم الري الحديثة فان الكمية التي يحتاجها الفدان اكبر من الكمية المضافة في حالة أراضي وادي النيل بنسبة 25 – 30 % أي يحتاج إلي 55 وحدة ازوت، 55 وحدة فوسفور، 25 – 35 وحدة بوتاسيوم لذا يجب إضافة ما يعادل 150 كجم سوبر فوسفات كالسيوم، 150 كجم سلفات نشادر، 25 كجم سلفات بوتاسيوم بالإضافة إلي الكمية التي تمت إضافتها أثناء الخدمة و الكمية التي تضاف بعد الخدمة يجب إضافتها في الأسابيع الستة الأولى بالنسبة لعنصري الفوسفور و البوتاسيوم أما بالنسبة لعنصر النيتروجين فتقسم الكمية على الثلاثة شهور كاملة مع استبدالها بحامض النيتريك بعد حساب عدد الوحدات إذا لزم ذلك.
أما بالنسبة للتسميد بالرش فيجب ما يلي :
1 – الرش بالكبريت الميكرونى بمعدل 250 جم/100 لتر ماء و ذلك مرتين على الأقل الأولى عند بدء خروج البراعم و الثانية بعد الأولى بخمسة عشر يوما للوقاية و التغذية.
2 – الرش بمنقوع السوبر فوسفات بمعدل 6 كجم سوبر فوسفات كالسيوم تنقع لمدة ليلة في جردل بلاستيك ثم يؤخذ المنقوع ليكمل إلي 250 – 350 لتر ماء و يرش للفدان الأولى عند بدء العقد و الثانية بعدها بأسبوعين و في حالة المحصول الجاف تضاف رشة ثالثة عند بدء اصفرار النباتات.
3 – الرش بالعناصر الصغرى المخلبية مرتين في العروة النيلية لتفادى اللون الأخضر الفاتح خاصة في الأصناف الحساسة للون الفاتح و ذلك بمعدل 200 جم حديد + 100 جم زنك + 100 جم منجنيز مخلبي لكل فدان.
رجوعيتم جمع المحصول الأخضر بعد تطاير الندى في الصباح أو المساء و يوقف الجمع في العروة الصيفي أثناء الظهيرة و يتم الجمع بالستارة كل 2 يوم للأصناف الرفيعة القرون Ex tera fine و كل 3 – 4 يوم للأصناف المتوسطة السمك Fine type و كل أسبوع للأصناف السميكة Bobby type.
و متوسط المحصول للأصناف المتوسطة السمك يبلغ حوالي 4 طن لكل فدان و يتم الجمع لمدة 3 – 4 أسابيع تبعا للعروة و نوع التربة و العناية بالخدمة أما في الأصناف الرفيعة فان المحصول ينخفض إلي 3 طن للفدان.
أما المحصول الجاف فانه يتم جمعه مرة واحدة في آخر عمر النبات و يعطى الفدان 250, 1 – 750, 1 طن للفدان و يحتاج إلي تخزين بعناية.
تختلف الأصناف المنزرعة باختلاف الغرض منها حيث توجد أصناف من الفاصوليا تزرع للمحصول الجاف أو المحصول الأخضر أو لكليهما معا كذلك فان أصناف المحصول الأخضر تختلف باختلاف الغرض منه إما للسوق المحلى أو للتصدير للدول العربية أو أوربا و لكل من هذه الأسواق ذوقه الخاص.
تصدر الفاصوليا الخضراء إلي الدول الأوربية و كذلك الدول العربية و تقسم الفاصوليا الخضراء عالميا إلي ثلاثة أقسام للتصدير تبعا لسمك القرن .
و تشمل الأصناف ذات سمك القرن الأخضر لا يزيد عن 6 ملليمتر.
القرن متوسط السمك و تشمل الأصناف ذات السمك ما بين 6 – 8 مم.
سميكة القرون و تشمل الأصناف ذات سمك القرون اكثر من 8 مم مع ملاحظة أن سمك القرن الأخضر صفة وراثية و إن كانت تتأثر بالبيئة إلا أن هذا التأثير محدود جدا كذلك وجد أن تأخير ميعاد الجمع يزيد من سمك القرون و يفقد صلاحيته للتصدير نتيجة زيادة الألياف أو بدء تكوين البذور أو التواء القرن تبعا لدرجة التأخير في الجمع و تبعا للصنف إما التبكير في جمع القرون فان القرون تكون فعلا رفيعة نوعا إلا أنها غير مكتملة النضج فان قابليتها للتداول تصبح ضعيفة جدا.
و فيما يلي أصناف الفاصوليا الخضراء التي تنجح زراعتها في مصر تبعا للأقسام السابقة:
و هذه المجموعة من الأصناف لا يفضل زراعتها للاستهلاك المحلى لاحتياجها إلي معاملات خاصة بعد الجمع و لكن تزرع في مصر للتصدير.
صنف محلى مستنبط بمعهد بحوث البساتين و سمك القرن 6 مم و طول القرن 13 سم و لونه اخضر داكن خال من الألياف و هو ناتج بالتهجين بين الصنفين جيزة 3 × فان دى قلنيف و هو مقاوم لفيرس الفاصوليا العادي Bcmv و يتحمل تأخير الجمع عند الضرورة إذ لا يحدث استطالة في القرون أو تكوين ألياف.
اختير هذا الصنف من مجموعة كبيرة من الأصناف تحت الظروف المصرية و يتميز بان سمك القرن 6 مم و طوله 18 – 20 سم و لونه اخضر داكن، قليل الألياف و مقاوم لفيروس الفاصوليا العادية B cmv كذلك يتميز بتبكيره 6 أيام عن الأصناف المنزرعة بمصر و يلاحظ أن تأخير جمع هذا الصنف يسبب استطالة القرون، عموما الأصناف الرفيعة القرون تجمع كل 48 ساعة تقريبا، تبلغ الصلاحية لتصدير الأخضر 95 % (ماعدا أول جمعه) و لون البذرة الجافة بنى داكن و مع انه يصاب بالصدأ إلا انه اكثر مقاومة للإصابة بالصدأ عن الأصناف المنزرعة حاليا و يتميز هذا الصنف أيضا بارتفاع طول النباتات و انه الصنف الوحيد الذي يحمل قرونه على قمة النباتات أي أن التزهير قمى في هذا الصنف و يمكن جمع المحصول الأخضر لمدة 3 – 4 أسابيع متوالية مع الخدمة الجيدة.
صنف رفيع القرون يبلغ طول القرن 11 – 12 سم، النمو الخضري اقل قليلا من الصنف مورجان و يزهر و ينتج محصولا بعد الصنف مورجان بأسبوع إلا أن القرن لا يزيد طوله عن 12 سم و يتميز أيضا ببطيء تكوين البذور داخل القرن و بطيء في تكوين الألياف.
و فيما يلي وصفا لأصناف هذه المجموعة :
من احسن الأصناف للمحصول الأخضر للسوق المحلى مع صلاحيته للتصدير و ذلك لتحمله للظروف السيئة الغير مناسبة التي قد تصادف الزراعة و القرون سمكها 8 مم ذات طول 12 سم و ذو كفاءة إنتاجية عالية و تحتاج إلي كميات اكبر من الأسمدة خاصة العناصر الصغرى مثل الحديد المخلبي (200 جم/فدان) و الزنك المخلبي و المنجنيز المخلبي (100 جم/فدان لكل منهما).
من الأصناف المطلوبة للسوق الأوربي و ذو جودة إنتاجية ممتازة إذ تتميز القرون بلون اخضر داكن و يبلغ طول القرن 11 سم و سمكه 7 مم و نسبة الصلاحية للتصدير عالية إذ تبلغ 80 – 90 % في اغلب الجمعات إذا تمت العناية بالنباتات.
نجح في التصدير إلي هولندا و سمك القرن 8 مم و طوله 12 سم و القرون ذات لون اخضر داكن.
من الأصناف التي تتحمل الظروف البيئية المغايرة و يتحمل درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة بدرجة معقولة و نجحت زراعته في المنوفية و طول القرن 11 سم و ذو سمك 8 مم و نجح تصديره إلي هولندا.
صنف صدر إلي هولندا و لا يتحمل تذبذبات درجات الحرارة و القرون مشابهة للصنف تسمان .
من الأصناف المتوسطة السمك إلا أنها ارفع هذه المجموعة إذ أن سمك القرن 5, 6 مم و طول القرن 13 سم و لقد صدر إلي هولندا و إنجلترا و ذو كفاءة إنتاجية عالية و يتميز بلون اخضر داكن.
من الأصناف التي تتحمل درجات الحرارة المنخفضة و المرتفعة و ذو كفاءة إنتاجية عالية و سمك القرن 8 مم و طول القرن 12 سم.
من الأصناف التي تتحمل انخفاض و ارتفاع درجات الحرارة و نجح جيدا في الزراعة تحت الأنفاق (البلاستيك) و القرون ذات لون اخضر داكن و سمك القرن 7 مم و طول القرن 11 سم.
من الأصناف التي تتحمل انخفاض و ارتفاع درجات الحرارة و نجح في الزراعة تحت الأنفاق و القرون جيدة إلا أن النباتات تحتاج إلي أسمدة اكبر من البوتاسيوم لذا يفضل الرش بالبوتاسيوم بالإضافة إلي الأسمدة المشار إليها سابقا.
(تحت التسجيل) من الأصناف الجديدة ذات لون اخضر داكن و سمك القرن 0, 7 مم و طول القرن 11 سم.
(تحت التسجيل) من الأصناف الجديدة أيضا تتميز باللون الأخضر الداكن و القرن اسمك قليلا من الصنف السابق إذ يبلغ 5, 7 مم و طول القرن 12 سم.
صنف ثنائي الغرض للمحصول الأخضر و الجاف القرون ذات سمك 12مم و طول القرن 12 سم ذو تحمل للظروف المغايرة جدا.
يبلغ متوسط وزن مائة بذرة 32 جم مقاومة لفيروس موزاييك الفاصوليا العادي BCMV.
يبلغ متوسط وزن مائة بذرة 43 جم مقاوم للفيروس BCMV بالإضافة إلي تحمله للإصابة بالصدأ.
يبلغ متوسط وزن مائة بذرة 52 جم مقاومة للفيروس BCMV و أيضا تحمله للصدأ و هو أبكرالأصناف الجافة بحوالي 6 – 7 أيام عن الصنفين السابقين.
رجوعيبدأ موسم الجمع بعد 60 – 80 يوما و قد تطول إلي 90 يوما في بعض الأصناف أو العروات و يمكن أن تجمع من 4 – 8 مرات حسب الصنف المنزرع و موسم الإنتاج و تجمع القرون الخضراء قبل اكتمال تكوين البذور حتى لا تصبح القرون متليفة غير صالحة للاكل، ايضا لا تكون في عمر اصغر من اللازم حتى لا تذبل بسرعة و تكون القرون ذات لون اخضر و قوام متماسك ملساء ليس بها أية انبعاجات و متجانسة منتظمة الشكل لحمية خالية من الألياف تتقصف أطرافها بسهولة عند ثنيها.
يفضل قطف قرون الفاصوليا الخضراء في الصباح بعد زوال الندى أو بعد الظهر بعد خفة حرارة الشمس حتى لا تظهر تبقعات سوداء على القرون نتيجة قطرات الماء أو إصابتها بالليونة و الذبول نتيجة تعرضها لأشعة الشمس المباشرة ظهرا حيث يزداد معدل تنفسها و فقدها للماء و بالتالي تقل جودتها.
و يتم القطف بان يمسك القرن من ناحية العنق عند اتصاله بالفرع و يلف في عكس الاتجاه فينفصل من على النبات مع احتفاظه بالعنق (السنارة) مع مراعاة عدم جذب الأفرع الأخرى خوفا من تكسيرها و عادة يفضل جمع القرون الخضراء في عبوات ملساء من الداخل مثل الجرادل البلاستيكية.
يتم فرز قرون الفاصوليا الخضراء من مكان مظلل من الحقل (تحت تعريشة) أو في بيوت التعبئة في حالة التصدير و ذلك على مناضد مغطاة بمفارش من القماش أو البلاستيك النظيف مع استبعاد القرون الغير ممثلة للصنف و المصابة بالأمراض و الحشرات و التي بها أضرار ميكانيكية أو كسور أو جروح أو تبقعات أو المصابة بالصدأ و يجب ألا تكون القرون مبتلة بالندى أو المطرو يلاحظ عند إجراء عملية الفرز عدم ترك الفاصوليا في أكوام كبيرة خاصة في حالة التصدير بل توضع في مراود غير مرتفعة حتى يسهل فرزها و تعبئتها و يتم ذلك بتركها لمدة ساعتين بعد الجمع في الجو العادي حتى يجف ما عليها من ندى ثم تبدأ عملية الفرز.
تعبأ الفاصوليا الخضراء في مصر في اجولة من الخيش تسع حوالي 40 كجم و هذه الطريقة غير سليمة حيث تتسبب في رفع نسبة الأضرار و تكسير القرون خلال مراحل التسويق المختلفة. إلا انه يفضل تعبئة الفاصوليا كما يلي:
يجب تعبأة قرون الفاصوليا الخضراء في صناديق بلاستيكية يتوافر فيها شروط العبوة الجيدة ملساء من الداخل و جيدة التهوية تسع حوالي 10 – 12 كجم كما يمكن استخدام الأقفاص الجريد على أن تبطن من الداخل بالكرتون المضلع مع مراعاة ألا تكون القرون أعلى من حافة العبوة حتى تتجنب ضغط العبوات العليا على القرون أو كسبها.
تعبا قرون الفاصوليا الخضراء للتصدير في عبوات من الكرتون المقوى و المشمع من الداخل و ذات فتحات طولية للتهوية سعة من 3 – 5 كجم مسجل على خارجها بيانات عن اسم النوع و الصنف و المزرعة و المصدر، … الخ و في هذه العبوات توضع القرون في رصات منتظمة مع تماثل طول القرون، خالية من العيوب التجارية و يلاحظ انه يجب ألا تمتلئ العبوة بأزيد من حافتها حتى لا تضار القرون نتيجة للتزاحم أو تملأ العبوة ناقصة لكي لا تتخلخل القرون بالداخل.
تستخدم الأكياس الشبكية أو السلوفان سعة ربع إلي نصف كيلوجرام ثم تعبا في علب من الكارتون.
من أهم هذه الأمراض
تحدث هذه الظاهرة نتيجة تعرض الأوراق و القرون لحرارة الشمس الشديدة و تظهر الأعراض على الفاصوليا خاصة في العروة الصيفي
تتكون مساحات ميتة بنية اللون غير منتظمة الشكل قد تشمل سطح الوريقة كله و عند اشتداد الإصابة ينفصل النسيج المصاب عن السليم بنسيج لونه بنفسجي محمر.
تتكون بقع بنية فاتحة و غير منتظمة الشكل تكون غائرة نوعا و خاصة فوق البذور قد يكون لون هذه البقع احمر في بعض أصناف الفاصوليا
المقاومة :
يؤثر الصقيع تأثيرا سيئا على محاصيل العائلة البقولية عموما و بالأخص الفاصوليا و ينتج عنه موت الأوراق، السوق، الأزهارو بالتالي تحولها إلي اللون الأسود.
تقليل ضرر الصقيع
يمكن تقليل الضرر الذي ينجم عن الصقيع برى النباتات في الأيام التي يخشى فيها من وجود الصقيع.
ظهور فجوات بنية اللون في مركز البذور بالفلقات و يمكن رؤيتها عند فصل الفلقتين عن بعضهما و السبب هو نقص عنصر المنجنيز.
المقاومة
إضافة كبريتات المنجنيز عن طريق التربة أو عن طريق الرش على النباتات في مرحلة مبكرة.
تتسبب هذه المجموعة من الأمراض عن فطريات عديدة ساكنة في التربة.
الأهمية الاقتصادية لهذه الأمراض:
يتسبب عن هذه الأمراض قلة عدد النباتات المنزرعة في وحدة المساحة و قد تصل هذه النسبة في بعض الأحيان إلي 30 – 40 % و ضعف في النمو الخضري و بالتالي نقص المحصول.
أ – أعراض الإصابة بأمراض اعفان الجذور
تظهر الأعراض على صورة بقع بيضاوية غائرة بنية إلي حمراء على السويقة الجنينية السفلي للبادرات و في حالة الإصابة الشديدة تؤدى إلي تحليق الساق و قد يمتد العفن حتى نخاع البادرة مسببا لونا بنيا ضاربا إلي الحمرة في الأنسجة المصابة و غالبا ما يؤدى ذلك إلي موت البادرات المصابة .
تظهر الإصابة بعد الإنبات بفترة وجيزة على صورة عفن جاف في الجزء العلوي من الجذر الوتدي و الجزء السفلي من السويقة الجنينية السفلي و يأخذ النسيج المصاب لونا احمر في البداية ثم يتحول تدريجيا إلي اللون البني القاتم، و يتحلل النسيج المصاب و تظهر به شقوق طولية مما يجعل النبات يتعرض للإصابة بكائنات أخرى تؤدى إلي تلف المجموع الجذري و بالتالي اصفرار و جفاف أوراق النبات تدريجيا ثم موته.
تتعفن البذور إذا أصيبت في بداية مراحل إنباتها و بالتالي تؤدى إلي إصابة البادرات عند سطح التربة ثم سقوطها، إذا أصيبت النباتات الكبيرة يظهر عليها بقع مائية تمتد طويلا على الساق على صورة خطوط طولية بين أنسجة القشرة اللينة.
تظهر الإصابة على صورة مناطق مائية غير منتظمة الشكل على السوق ثم تنتشر بسرعة إلي باقي أجزاء النباتات مكونة عفنا مائيا يؤدى إلي موت النباتات، و يلاحظ أيضا تكون أجسام حجرية لونها اسود داخل النمو الميسليومى الأبيض للفطر و قد يجف الجزء المصاب في الجو البارد الجاف مع ملاحظة انه يصيب الساق و كذلك القرون.
تتأثر الفاصوليا اكثر من غيرها بهذا المرض حيث يصيب الفطر البادرات في منطقة السويقة الجنينية السفلي و تموت البادرات مبكرا، كذلك يصيب النباتات الكبيرة فوق مستوى سطح التربة و تتكون بقع ذات لون بنى قاتم إلي اسود و تظهر بها حلقات مركزية غالبا ما تكون على جانب واحد من الساق.
الأعراض
تبدأ أعراض الإصابة بالذبول على صورة اصفرار تدريجي بالأوراق السفلي و يكون غالبا في جانب واحد من النباتات و مع تقدم الإصابة يظهر نفس الأعراض على الأوراق العليا، بينما تسقط الأوراق السفلي و بذلك يجف اغلب المجموع الخضري و يموت النبات و تظهر الحزم الوعائية في السوق و أعناق الأوراق و قد أخذت لونا بنيا فاتحا.
الظروف الملائمة لانتشار الإصابة بأمراض اعفان الجذور:
1 – درجات الحرارة المنخفضة.
2 – زيادة الرطوبة في التربة حيث وجد أن درجة الحرارة من 18 – 24°م و طوبة نسبية 95 % تشجع على انتشار فطر العفن الأبيض.
3 – ارتفاع مستوى الماء الأرضي.
4 – ملوحة التربة.
5 – التربة الثقيلة سيئة الصرف.
6 – الجو البارد الرطب خاصة في حالة العفن البيثيومى.
الظروف الملائمة لانتشار الإصابة بأمراض الذبول
1 – الرطوبة الأرضية المنخفضة نسبيا.
2 – التربة الرملية الخفيفة.
3 – درجة حرارة مرتفعة نسبيا من 25 – 30°م.
4 – انتشار الديدان الثعبانية بالتربة (النيماتودا).
الاتجاه العام الآن هو اتباع أسلوب المقاومة المتكاملة بداية من اختيار التربة المناسبة ثم إعدادها الإعداد الجيد و العناية التامة بالعمليات الزراعية من الألف إلي الياء، و كذلك استخدام بدائل المبيدات عن طريق المقاومة الحيوية المستخلصات النباتية، … الخ و ذلك بقصد ترشيد استخدام المقاومة الكيماوية إلي اكبر قدر ممكن حتى نتلافى خطورتها سواء على صحة الإنسان أو الحيوان أو الأسماك و الطيور، … الخ و كذلك منعا للتلوث البيئي.
يجب التركيز عليها جيدا حيث هي الأساس لان معظم عملياتها يمكن للزراع التحكم فيها بسهولة و هي تشمل ما يلي :
1 – اتباع دورة زراعية مناسبة بحيث تتلافى زراعة محاصيل بقولية عدة سنوات في ارض واحدة و ذلك حرصا من انتقال المسببات المرضية و زيادة اللقاح في التربة حيث أن مسببات اعفان الجذور و الذبول تكون كامنة في التربة كما ذكر ذلك سابقا.
2 – شراء التقاوي من مصدر موثوق منه.
3 – زراعة الأصناف القادرة على تحمل الإصابة و قد توفرت في الآونة الأخيرة.
4 – حرث المخلفات النباتية حرثا عميقا في التربة أو جمعها و حرقها بعيدا عن التربة.
5 – العناية بخدمة الأرض من حيث الحرث، التنعيم للتربة يقلل الرطوبة و بذلك نتلافى المسببات المرضية لاعفان الجذور و الذبول.
6 – غمر الأرض بالماء لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل قبل الزراعة و ذلك في حالة وجود الفطر المسبب بالعفن الأبيض بصورة وبائية و ظهور الأجسام الحجرية.
7 – عدم تعميق الزراعة حتى تظهر البادرات سريعا فوق سطح التربة.
8 – التوقف عن العزيق عند ظهور الإصابة للمحافظة على الجذور الثانوية الجديدة التي يكونها النبات و إجراء العزيق السطحي.
9 – تحسين التهوية في الزراعات المحمية.
قبل الزراعة :
معاملة بذور الفاصوليا بالمطهرات الفطرية التالية:
1 – ريدوميل بلاس 1 جم أو بريفيكور N 1 سم3/كجم بذرة.
2 – ريزوليكس/ثيرام 5, 1 أو مونسرين 5, 1 جم/كجم بذرة.
3 – تومسين M 70 % 1جم/كجم بذرة أو تكتو 45 % 1 سم3/كجم بذرة أو بمعنى آخر (ريدوميل 1 جم + ريزوليكى 5, 1 جم + تومسين 1جم) /كجم بذرة.
مع ضرورة تندية البذور قبل المعاملة بقليل من الماء أو الصمغ العربي أو مادة الترايتون أو النشا و ذلك لضمان التصاق المطهرات الفطرية على سطح البذرة جيدا و ذلك يتم قبل الزراعة مباشرة.
ملحوظة هامة يجب إضافة كل مطهر على حده (أي على التوالي) بعد الزراعة بحوالي أسبوعين .
عند ظهور أعراض الإصابة بأمراض اعفان الجذور و الذبول و التأكد منها جيدا يمكن عمل محلول من المطهرات الثلاثة و بالتركيزات المذكورة سابقا و تضاف إلي لتر ماء و تحضر الكمية المطلوبة من المحلول حسب الاحتياج، و يضع حوالي كوب شاي بجوار جذر النبات ذو الإصابة المتوسطة و يستبعد النبات الذي به إصابة شديدة و الذي لا أمل فيه و يحرق بعيدا عن الحقل.
و تتم الإضافة بطريقتين
أ – يحضر المحلول كما ذكر سابقا في برميل نظيف و بالنسب المقررة و يضاف حوالي كوب شاي بجوار النبات عن طريق عامل و معه الجردل و الكوب.
ب – وضع المحلول في الرشاشة بعد تحضيره في البرميل و بواسطة الرشاشة التي تم استبعاد الفونيه منها و يمكن حقن النباتات المصابة بجوار الجذر مباشرة و ذلك للسهولة و السرعةالتوقيت.
يعتبر ذلك أسلوب جديد في المقاومة و ذلك بغرض ترشيد استخدام المبيدات و من أمثلتها مستخلص الثوم – زيت الكافور و غير ذلك من المستخلصات.
يعتبر مجال آخر في المقاومة حيث يتم زراعة بعض النباتات مع المحصول الرئيسي و هذه النباتات لها القدرة على جذب الآفات الضارة و كذلك التأثير على نمو جراثيم الفطريات الممرضة للنبات الرئيسي لذلك فان نباتات التحميل يجب أن تكون مدروسة جيدا مما سبق نستنتج أن الطرق التي ذكرت في المقاومة و التي لا يتم استخدام المبيد أو تستخدم بجرعات اقل أو عدد مرات قليلة في إضافته للنباتات (بالطرق المختلفة) كل ذلك يؤدى إلي ترشيد استخدام المبيدات و بالتالي نحافظ على البيئة من التلوث و في النهاية نحافظ على صحة الإنسان و الحيوان … الخ
الأعراض
عبارة عن بقع سوداء غائرة على القرون، يظهر في وسطها إفراز فاتح اللون كما تتكون بقع مماثلة على الأوراق الفلقية و النباتات الصغيرة و تموت السوق بمجرد خروجها فوق سطح التربة.
طرق انتشار الإصابة
الظروف الملائمة
إنثراكنوز الفاصوليا على القرون
المقاومة
المقاومة الزراعية
المقاومة الكيماوية
يعتبر هذا المرض خطيرا حيث يصيب نباتات العائلة البقولية و العائلة القرعية و الباذنجانية و الصليبية و أيضا الجزر و الخس و الكرفس.
الأعراض
تبدأ الإصابة في الفاصوليا على صورة مناطق مائية غير منتظمة الشكل على الساق ثم تنتشر بسرعة في باقي أجزاء النبات مكونة عفنا طريا مائيا يؤدى إلي موت النبات، قد يحدث جفاف في الجزء المصاب عندما يكون الجو باردا جافا.
الظروف الملائمة
درجة الحرارة دافئة حوالي 23 °م و رطوبة نسبية حوالي 95 % ينمو الفطر بغزارة و يكون نسيجا قطنيا ابيض اللون على السوق و الأوراق و القرون تظهر الأجسام الحجرية للفطر على هذا النمو القطني و لونها اسود و صلبة و صغيرة، يعيش الفطر بواستطها في التربة بين المواسم المحصولية، تنتشر جراثيم الفطر بواسطة الهواء و يساعد الجو الرطب المعتدل الحرارة لفترة طويلة على انتشار الإصابة و زيادة حدوثها.
المقاومة
المقاومة الزراعية
المقاومة الكيماوية
يمكن الرش بأحد المبيدات التالية مرة كل 10 – 15 يوم حسب شدة الإصابة و الظروف الجوية المحيطة بالنبات :-
الرونيلان بمعدل 100جم 100/لتر ماء أو التوبسين M 70 % بمعدل 100 جم/ 100 لتر ماء.
يعتبر مرض الصدأ من الأمراض الاقتصادية الهامة على الفاصوليا حيث يسبب خسائر كبيرة في حالة توافر الظروف الملائمة لانتشاره و كذلك زراعة الأصناف القابلة للإصابة، تصل الخسارة أحيانا من 30 – 50 % من المحصول الناتج و هذه تكون في الكم و النوعية حيث يسبب احتراق الأوراق و بالتالي تشوه القرون.
صدأ الفاصوليا على الأوراق والقرون
الأعراض
تظهر الأعراض غالبا على الأوراق على صورة بثرات و تكون على السطح السفلي للأوراق خلال خمسة أيام من الإصابة و تكون على شكل بقع صفراء صغيرة قطرها 1 – 2 مم و تكون بيضاء اللون و مرتفعة قليلا عن سطح الورقة، مع تقدم الإصابة تظهر بقع أخرى بنية إلي حمراء على شكل حلقة حول الإصابة الأولية تعرف بالطور اليوريدى و مع استمرار تقدم الإصابة يتحول الطور اليوريدى إلي الطور التيليتى الذي تكون جراثيمه ذات لون بنى ضارب إلي السواد، يصاحب ذلك تلون الأوراق المصابة باللون الأصفر فالبنى ثم جفافها و سقوطها و في حالة الإصابة الشديدة تصاب القرون كذلك بالصدأ و يتشوه شكلها و تصبح غير صالحة.
طرق انتشار المرض
الظروف الملائمة لانتشار الإصابة
أ ) الرش الوقائي .
باستعمال أحد المبيدات التالية مرة كل 15 يوم بعد الزراعة بـ 45 يوم خاصة في الزراعات المتأخرة:-
الكبريت الميكرونى بمعدل 250 جم/100 لتر ماء،مانكوبر بمعدل 250 جم/100 لتر ماء.
ب ) الرش العلاجي
عند ظهور الإصابة بنسبة حوالي 3 – 5 % يجب استعمال المبيدات التالية على التوالي مرة كل 10 – 15 يوم حسب شدة الإصابة:-
يعتبر من أهم الأمراض التي تصيب الفاصوليا و يسببه الفطر بوترايتس و يسبب فقدا كبيرا في المحصول أثناء التصدير نتيجة زيادة الرطوبة و ملامسة القرون المصابة للسليمة أثناء التعبئة.
و هو كما ذكر يتسبب عن فطر الاسكليروتينيا و يصيب القرون في الحقل نتيجة ملامسة القرون لسطح التربة و بذلك يظهر على القرون نمو ميسليومى ابيض اللون خلال مراحل التسويق في حالة الإصابة الشديدة تظهر الأجسام الحجرية للفطر وسط النمو الميسليومى الأبيض.
يصيب هذا المرض قرون الفاصوليا أثناء النقل و التسويق و التصدير نتيجة تلوث القرون الملامسة لسطح التربة بالفطر المسبب للمرض حيث تظهر الأعراض على هيئة بقع مائية على القرون، ينمو عليها ميسليوم ابيض قطني يؤدى إلي تحلل القرون.
و قد سبق ذكره فيما سبق.
و ننصح الاخوة المزارعين لمقاومة هذه الأمراض اتباع ما يلي :-
1 – رش النباتات قبل العقد بمبيد الرونيلان بمعدل 150 سم3/100 لتر ماء أو التوبسين M 70 % بمعدل 100 جم/ 100لتر ماء على أن يوقف الرش عند بداية العقد و جمع القرون.
2 – الاعتدال في الري و ذلك لتقليل الرطوبة حول النباتات.
3 – الزراعة في تربة خفيفة جيدة الصرف.
يعتبر من أهم الأمراض البكتيرية التي تصيب الفاصوليا و البقوليات عموما في جمهورية مصر العربية و يسبب خسائر كبيرة في المحصول.
الأعراض
دورة الحياة و طرق الانتشار
توجد البكتيريا على المخلفات النباتية المصابة و في البذور و تبدأ الإصابة بنمو البكتيريا على القصرة و بذلك تحدث العدوى للأوراق الفلقية أثناء اختراقها للتربة، تدخل عن طريق الشقوق في طبقة الكيوتيكل و يزداد النمو بين صفوف الخلايا حتى يصل إلي الأنسجة الوعائية حيث ينتقل خلال أوعية الخشب و بذلك تحدث الأعراض على الساق و الأوراق يمكن أن تحدث الإصابة بعد ذلك عن طريق دخول البكتريا المنقولة بواسطة.
تنتقل البكتريا بين صفوف الخلايا و تفرز أنزيمات تحلل الصفيحة الوسطى لهذه الخلايا مما يؤدى إلي تحلل الأنسجة و موتها و ظهور الأعراض السابق ذكرها، كذلك فان الميكروبات تخرج من الثغور إلي سطح الأوراق.
اللفحة العادية فى الفاصوليا على الأوراق
المقاومة
اللفحة العادية فى الفاصوليا على القرون
الأعراض
تبدأ الإصابة في الحقل خاصة إذا زرعت بذور حاملة للبكتريا و كانت إصابتها شديدة و بالتالي قد تفشل البذور في الإنبات أو قد تموت البادرة و هي مازالت في حالة نمو الأوراق الفلقية، تتكاثر البكتريا في الحزم الوعائية و تكون النباتات المصابة متقزمة و تأخذ الأوراق السفلي غالبا شكلا ملعقيا و مع تقدم الإصابة تتلون المسافات بين العروق في الورقة بلون اصفر ثم تتحول إلي اللون البني الفاتح ثم تذبل و تسقط في نهاية الأمر.
يشتد الذبول في الجو الحار الجاف و تتلون الجزم الوعائية بلون بنى خاصة في الجزء السفلي من النباتات و لا تظهر أعراض خارجية على القرون رغم إصابتها داخليا.
المقاومة
ينتشر هذا المرض في جميع أنحاء العالم و هو من الأمراض التي تسبب خسائر اقتصادية.
الأعراض
تظهر على الأوراق بقع مائية صغيرة منتظمة و تكون على السطح السفلي للأوراق ثم تكبر هذه البقع في الحجم و تتميز بإحاطتها بهالة من أنسجة صفراء قطر البقع يتراوح ما بين 3 – 6 مم و قد يصل عرض الهالة الصفراء إلي 5,2 سم.
ربما تظهر على القرون بقع بيضاوية مائية يتراوح قطرها ما بين 6 – 9 مم و تصبح غائرة إلي حد ما لونها محمر مع تقدمها في العمر و غالبا يوجد إفراز بكتيري كريمي اللون على البقع الملونة على القرون. غالبا ما تلتحم البقع المتكونة سواء على الأوراق أو القرون.
البذور المصابة تكون اصغر حجما من البذور السليمة.
عوامل انتشار الإصابة
الجو الملبد بالغيوم – العرض المميز يظهر بوضوح في درجات الحرارة المنخفضة (16 – 20°م) لكن المرض ينتشر عند درجة الحرارة الدافئة.
المقاومة
الأعراض:
ظهورعقد أو انتفاخات على الجذور و يعقب ذلك اصفرار المجموع الخضري و صغر حجمه و قد يذبل عند ارتفاع درجات الحرارة و أحيانا يموت النبات>
تكثر الإصابة بالنيماتودا في الأراضي الرملية و الخفيفة.
نيماتودا تعقد الجذور على الفاصوليا
الظروف الملائمة
المقاومة
الفايديت 34 % بمعدل 2 لتر من المبيد / للفدان أو الفيوردان 10 % بمعدل 20 كجم / فدان.
و يجب استعمال هذه المبيدات في الأراضي الموبوءة بالنيماتودا قبل زراعتها بالمحصول الجديد.
من أهم هذه الأمراض
1 – الموزايك العادي في الفاصوليا Common Bean Mosaic
Virus
الأعراض
فيروس التبرقش العادى فى الفاصوليا
الظروف الملائمة
أ – الحرارة المعتدلة ب – الجو الجاف
وسائل انتقال المرض
المقاومة
الأعراض
التفاف الوريقات إلي اسفل و انحناء النصل نفسه لاسفل عند نقطة اتصاله بالعنق، مع تبرقش واضح فيتقدم تدريجيا حتى يعم الاصفرار معظم النمو الخضري.
على عكس موازيك الفاصوليا العادي فان أعراض الإصابة بموازيك الفاصوليا الأصفر يزداد مع تقدم موسم النمو و يقل طول السلاميات في النباتات المصابة و يزداد تفرعها و يقل عقد القرون و تكون القرون المتكونة مشوهة.
وسائل انتقال المرض
المقاومة
تقضى الحشرة فترة الشتاء داخل أنفاقها و مع بداية فصل الربيع تبدأ نشاطها حيث تشتد الإصابة بها في شهري إبريل و مايو فتهاجم النباتات حيث تتغذى على جذورها تحت سطح التربة فتذبل النباتات ثم تموت و يتسبب عن ذلك غياب بعض الجورو حتى إذا تم ترقيعها فان الحقل تكون نباتاته غير منتظمة في النمو و تشتد في النمو و تشتد الإصابة بالحفار في الأراضي الخفيفة الرطبة.
المكافحة
في الأراضي الموبوءة يكافح الحفار بعد ريه الزراعة و قبل غروب الشمس بالطعم السام كما يلي:
هوستاثيون 40 % 25, 1 لتر أو المارشال بمعدل 25 % كيلو للفدان + 20 – 25 كجم جريش ذرة أو رده أو كسر أرز + ربع كجم عسل اسود و يخلط خلطا متجانسا بإضافة الماء تدريجيا حتى تصبح الخلطة قابلة للنشر (التوزيع) مع مراعاة أن يوضع الطعم السام بعد الري و عند غروب الشمس.
تتغذى يرقاتها على سيقان نباتات الفاصوليا و البسلة و اللوبيا فتقرضها عند سطح التربة حيث تموت البادرات و عند الحفر بجوار البادرات الميتة توجد الديدان و لونها اسود و مكورة.
المكافحة
عند بداية ظهور الإصابة بالديدان القارضة تكافح الحشرة بالطعم السام المكون من 15 كجم رده أو كسر أرز + 25, 1 لتر هوستاثيون 40 % أو مارشال 25 % بمعدل كجم للفدان على أن يضاف المبيد تدريجيا مع التقليب و يستكمل الخلط بالماء بحيث تكون الخلطة متجانسة و درجة تماسكها قابلة للتوزيع تكبيشا تحت الجور.
آفة شديدة الخطورة و تتغذى على عصارة النباتات و تبدأ الإصابة بها بظهور خربشة أو جروح للأسطح السفلية للأوراق يقابلها بقع حمراء باهته على السطح السفلي للأوراق.
المكافحة
1 – الرش بالكبريت الميكرونى بمعدل 8, 1 كجم 600/لتر ماء كل عشرة أيام.
2 – عندما تشتد الإصابة بالاكاروس تعالج النباتات بالمبيدات الموصى بها : نيرون 50 % بمعدل لتر/للفدان أو آورتس بمعدل 400 سم3/للفدان.
و تشتد الإصابة به في الربيع و الخريف حيث تكون الإصابة على الأسطح السفلية للأوراق مصحوبة بظهور الندوة العسلية و تشتد الإصابة في القمم النامية للنبات فتظهر الأوراق مجعدة و مشوهة و عند اشتداد الإصابة تتوقف القمم النامية عن الاستمرار في النمو و تتقزم النباتات و ينقل المن بعض الأمراض الفيروسية.
المكافحة
1 – التخلص من الحشائش.
2 – رش حواف الحقل المصاب قبل زيادة كثافة تعداد الآفة.
3 – علاج البؤر المصابة فقط.
4 – يكافح المن باستخدام أحد المركبات التالية.
- الصابون السائل بمعدل لتر/100 لتر ماء.
- الزيوت الخفيفة سوبر مصرونا بمعدل واحد لتر/100 لتر ماء.
- اكتليك 50 % بمعدل 25, 1 لتر/400 لتر ماء للفدان.
- ملاثيون 57 % بمعدل 5, 1 لتر/400 لتر ماء للفدان.
على أن يتم التركيز أثناء عملية المكافحة على الأسطح السفلية للأوراق.
يعتبر من الجذور من الحشرات التي تتغذى على عصارة النباتات في منطقة الجذور و في حالة شدة الإصابة يقضى على المحصول و يصيب الفاصوليا و البسلة و اللوبيا.
المكافحة
الرش بالملاثيون 57 % بمعدل 5, 1/لتر + 400 لتر ماء مع تركيز الرش في منطقة جذور النباتات.
تصيب يرقات الحشرة أوراق الفاصوليا و البسلة و اللوبيا و تتغذى عليها و في حالة شدة الإصابة تسبب أضرار للمحصول
المكافحة
1 – النقاوة اليدوية للطع كلما أمكن ذلك مع جميع اليرقات وإعدامها.
2 – استخدام الفيرمونات (الجاذبات الجنسية).
3 – عندما تشتد الإصابة يستخدم أحد المبيدات الموصى بها الآتية :-
تصيب اليرقات أوراق الفاصوليا و البسلة حتى تتغذى على النسيج الوسطى بين بشرتي الورقة و تظهر أعراض الإصابة على هيئة أنفاق متعرجة خالية من الكلوروفيل و عند شدة الإصابة تذبل الأوراق حتى الجفاف و الموت.
المكافحة
1 – نظافة الحقل من الحشائش.
2 – جمع الأوراق المصابة و حرقها.
3 – استخدام المصايد الصفراء اللاصقة.
4 - عندما تشتد الإصابة ترش النباتات بإحدى المواد الآتية :-
آفة شديدة الخطورة على زراعات الفاصوليا المبكرة في العروة النيلية و تشتد الإصابة بها في شهر أغسطس لذلك ينصح بالزراعة في أوائل سبتمبر للهروب من شدة الإصابة و اليرقات تصيب السيقان فتصبح هشه سهلة الكسر و شكل اليرقة دودية طرفها الأمامي مدبب و الخلفي عريض لونها سمنى باهت.
المكافحة
1 – إزالة النباتات المصابة بشدة و حرقها.
2 – استخدام السليكرون 72 % بمعدل ثلاثة أرباع لتر/400 لتر ماء أو لانيت 90 % بمعدل 300 جم/فدان و يراعى ذلك عند اشتداد الإصابة.
تعنى المكافحة الزراعية تهيئة الظروف البيئية حتى تبدو بشكل غير مناسب للآفة و ذلك إما بإحداث خلل في قدرتها التناسلية أو بالتخلص من عوائلها الغذائية أو بتهيئة الظروف المناسبة لاعدائها الحيوية حتى تقضى عليها و هي واسعة الانتشار و التطبيق داخل نظام المكافحة المتكاملة فمثلا لوحظ أن حرث الأرض في وجود رطوبة يساعد على تعريض الجعال إلي سطح التربة و كشفها حتى تتعرض لأشعة الشمس و أعدائها الحيوية.
أهم وسائل المكافحة الزراعية :
هي عملية الغرض منها تفكيك التربة و تؤثر هذه العملية على الحشرات إما بطريق مباشر حيث تقتل الأطوار الغير كاملة للحشرات في التربة و يحد العزيق من الحشائش التي تنمو على النباتات و التي تعتبر مصدر لجذب الحشرات و التي بدورها حجم المحصول.
يتبع المزارعون الدورة الزراعية بغرض الحفاظ على خصوبة التربة إلا أن إجراؤها قد يعمل على انخفاض الإصابة بالآفات التي تنتشر على المحصول ولكن يصعب عليها الاستمرار بنفس الكثافة العددية على محصول آخر لاحق خاصة إذا كان يتبع عائلة نباتية مختلفة.
تزداد الإصابة بالآفات في النباتات الكثيفة و المتشابكة و تقل الإصابة في النباتات ذات الكثافة القليلة.
يؤدى التسميد النيتروجيني إلي زيادة المجموع الخضري و الذي يجعل الأوراق غضة و هذا ما تفضله الحشرات التي تتغذى على الأوراق و لذلك يجب الاعتدال في الكميات المضافة من النيتروجين.
تعمل الحشائش و مخلفات المحاصيل كمخابئ تسكن فيها الآفة أو أحد الأطوار كعائل بحيث تصبح مصدرا لاصابة المحصول الجديد و لذلك فان التخلص من الحشائش و إعدام مخلفات المحصول يعتبر من اكثر عوامل تقليل الإصابة في المحصول.
لكل حشرة موسم للتكاثر و النمو تزداد فيها أعدادها و نشاطها و بالتالي ضررها على النبات كما أن لكل حشرة فترات معينة تقل فيها أعدادها و بالتالي ينخفض ضررها و قد يدخل بعضها في أطوار التوقف أو السكون و تزداد الأعداء الحيوية بالتغذية على الحشرات فتعمل على نقص أعدادها في الطبيعة و بالتالي هبوط مستوى الآفة إلي حد معين. و حتى تناقصت أعداد الآفة فان الطفيل أو المفترس يحرم من فريسته و تجرى عملية حفظ الأعداء الحيوية و ذلك باستخدام المبيدات الحشرية باستخدام جرعات منخفضة من المبيد الحشري لمكافحة الآفة أو بمعاملة مناطق محدودة من الحقل بالمبيد الحشري حيث يكون بعض المساحات في وسط الحقل في شكل شرائط في وسط الحقل على أساس انه يبدأ منها انتشار الأعداء الحيوية حتى نعوض البعض في مساحات التي عوملت بالمبيد.
و هي تمثل اكبر مجموعة من الكائنات الحيوية المستعملة في مجال الآفات و تعتبر بكتيريا الباسيللس من أهم مسببات الأمراض البكتيريا التي تنقل الأمراض للعديد من الآفات الحشرية كما تعتبر من أهم المبيدات البكتيرية التي تم تصنيفها في مجال المكافحة الميكروبية و يمتاز هذا المبيد بسهولة إنتاجه و فاعليته في إحداث المرض بالإضافة إلي انخفاض تأثيره على الأعداء الحيوية.
استعملت الفطريات في مكافحة الآفات حيث تلائم الرطوبة المرتفعة إنبات جراثيم الفطر و قد اظهر فطر الفرتيسيليم كفاءة عالية كبيرة للمن و الذبابة البيضاء خاصة عند استخدامه في الصوبات الزجاجية.
انتشر استخدام الفيروسات حاليا كطريقة ناجحة من طرق المكافحة البيولوجية و أهم أنواع الفيروسات التي تصيب الحشرات هما فيروس البوليهيدروزيس و فيروس الجانيولوزيس و قد استخدم الفيروس الأول في صورة معلق لمكافحة يرقات دودة ورق القطن و تحدث العدوى عن طريق التغذية على غذاء ملوث بجزيئات بللورات الفيروس و لكن معاملة مسبب المرض في الأطوار المقاومة بنجاح عن طريق الرش و التعفير و يستمر ثباته في الحقل لفترات كافية تتوقف على العوامل البيئية مثل الجفاف أو الإشعاع الشمسي و الحرارة و قد لوحظ عموما أن مسببات الأمراض لا تستمر فترة طويلة على المجموع الخضري للنبات و ربما كان ذلك بسبب تأثير أشعة الشمس و الأمطار أو الرياح و لكن إضافة بعض المواد المحسنة التي تطيل من فترات ثباتها على النبات.
غالبا ما تكون الغدد المنتجة للجاذبات الجنسية في الإناث ما بين الحاقات البطنية الأخيرة و تعمل الحشرات في تنظيم انطلاق الرائحة و عادة ما تفرز الرائحة في أوقات محددة أثناء اليوم و عموما فان الإناث لا تفرز الفيرمونات بعد خروج الحشرة الكاملة مباشرة و حتى يوم من الخروج و لكنها تبدأ عملية الإفراز بعد ذلك حتى يتم تلقيحها.
رجوعو يمكن ترتيب طرق المكافحة المتكاملة للآفات كالآتي:-